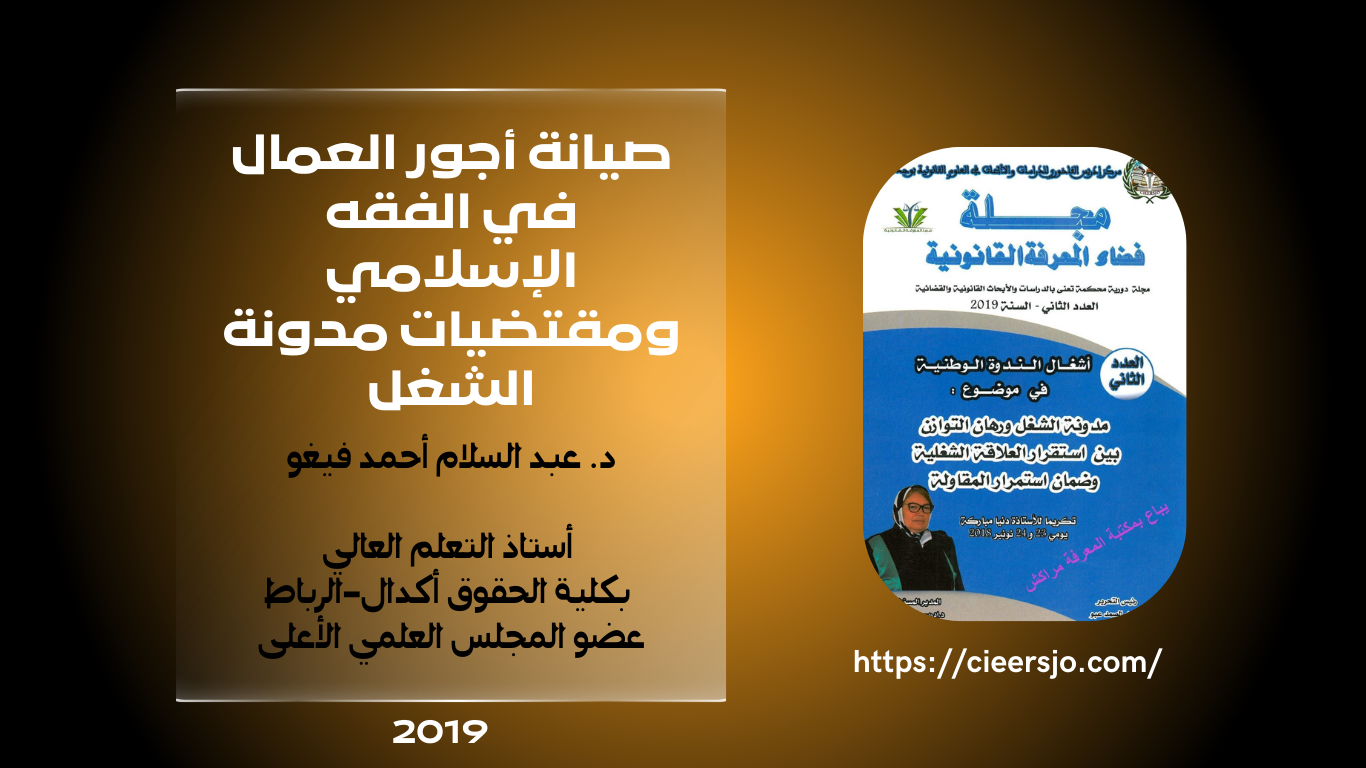مظاهر الأمن القانوني في القانون 49.16

دة.وردة غزال
أستاذة باحثة بكلية الحقوق بوجدة
هذا المقال منشور في العدد الأول * أكتوبر 2018* من مجلة فضاء المعرفة القانونية التي تصدر عن المركز.
يعتبر عقد الكراء عموما من العقود التي تشكل أهمية اقتصادية واجتماعية لارتباطه بفئة واسعة تجد في الكراء بديلا عن التملك لسبب أو لآخر.
والكراء التجاري بالخصوص يعتبر دعامة مهمة من دعائم الاقتصاد الوطني إذ لا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي دون ضمان استمرار واستقرار المؤسسات التجارية والحرفية والصناعية، والتي تحتاج إلى فضاء مكاني يشكل الإطار الذي تنموا فيه عناصرها المختلفة من زبناء وسمعة تجارية… لذلك لا يمكن الحديث عن التطور الاقتصادي إلا بتوفر عنصر الاستقرار في مواجهة مالك العقار.
وقد ظل المشرع المغربي وفيا للقواعد العامة في تنظيم عقد الكراء وظلت علاقة المكري بالمكتري-كيفما كان محل الكراء- خاضعة للحرية التعاقدية، إلا أن تطور الحياة الاقتصادية والتكنولوجية والمالية أثرت بشكل كبير على الأنظمة القانونية السائدة، وقصور ظهير الالتزامات والعقود عن مواكبة هذا التطور، أصبح لزاما وضع تنظيمات خاصة ومعاصرة تساير وتيرة التطورات المختلفة ووضع أنظمة خاصة لمختلف أنواع الأكرية. لذلك حلت إرادة المشرع محل إرادة الأطراف، إذ بتاريخ 24 ماي 1955 صدر ظهير ينظم أكرية الأماكن المخصصة للتجارة أو الصناعة أو الحرف[1]، حيث يتضح من ديباجة هذا الظهير بأن الهدف الأساسي من صدوره هو تفادي عدم الاستقرار الذي كانت تعرفه المؤسسات التجارية وحماية حقوق المكترين عن طريق الحد من تعسف المكرين، على أساس أن الحق[2] في الكراء يعتبر الدعامة الأساسية لاستقرار واستمرار الأصل التجاري كمقاولة تجارية أو صناعية أو حرفية، وكمشروع يساهم في حماية النشاط التجاري، ومن أهداف هذا القانون أيضا تلافي تعقيد الإجراءات، وضمان مسطرة مرنة في متناول الجميع[3]. غير أن تطبيق هذا الظهير أبان عن مجموعة من الاختلالات والاختلافات المتباينة سواء على مستوى محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض نفسها، أو على مستوى الفقه أيضا.
لذلك جاء المشرع المغربي بقانون 49.16[4] كبديل عن قانون 24 ماي 1955، ومن أجل إحاطة العلاقة التعاقدية التي تجمع بين طرفين مختلفين قد يصل تضارب مصالحها حد التنافر بسياج من المقتضيات التي تضمن قدر الإمكان تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين بشكل يوفر الأمن القانوني والقضائي المنشودين، ومحاولا بذلك إعادة الأمن والاستقرار للأصل التجاري والحفاظ على النشاط التجاري وتدعيم مناخ التجارة والاستثمار حتى ولو كان ذلك على حساب مالك العقار.
والملاحظ أن المشرع المغربي من خلال قانون 49.16 كان يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف[5] من بينها ضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، وضمان حماية حقوق كلا الطرفين، إلا أنه رغم ذلك ورغم التعديل التشريعي الذي عرفته نصوص ظهير 24 ماي 1955، طرحت العديد من التساؤلات لها ارتباط وثيق بالأمن القانوني موضوع الدراسة من حيث مدى انسجام نصوص قانون 49.16 مع متطلبات الحماية المنشودة للأصل التجاري؟ وما هي المصلحة الأجدر بالحماية، هل مصلحة المكري أم المكتري أم هما معا؟
وارتباطا بالموضوع تبقى الإشكالية المحورية للبحث والتي تؤطر موضوع الدراسة ممثلة في مدى توفق المشرع المغربي في إنتاج نصوص قانونية قادرة على تحقيق الأمن القانوني والقضائي اعتبارا لضرورة التوفيق بين مصلحتين متناقضتين، مصلحة المكري في الحفاظ على ملكيته المحمية دستوريا[6]، ومصلحة المكتري في الحفاظ على أصله التجاري؟ وذلك حتى لا يصبح الكراء التجاري مجالا خصبا لنزع الملكية العقارية ولتفادي أيضا امتناع مالكي العقارات عن كرائها والاستفادة منها وبالتالي التقليص من تمركز الاستثمار في بعض الفاعلين الاقتصاديين اللذين يمكنهم تملك العقارات.
هذا ما ستتم مقاربته دون القول بإمكان إعطاء الحلول اللازمة للصعوبات التي تثيرها نصوص قانون 49.16، بل الهدف من هذه الدراسة هي الوقوف عند بعض الإشكالات التي يطرحها هذا القانون.
ولمقاربة موضوع الأمن القانوني كركيزة أساسية للاستقرار والثبات في المراكز القانونية والعلاقات التعاقدية (المطلب الأول)، لا بد من تحديد بعض مظاهره في المنظومة الكرائية التجارية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الأمن القانوني ودوره في استقرار العلاقات التعاقدية
قبل الوقوف عند خصائص الأمن القانوني كمظهر من مظاهر دولة الحق والقانون (الفقرة الثانية) لا بد من تحديد مفهومه (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: مفهوم الأمن القانوني
تعريف الأمن القانوني[7] كمبدأ دستوري يعتبر من الأمور المستعصية انطلاقا من اختلاف التوجهات التي يمكن أن تنصب على هذا المفهوم كل من موقعه الخاص وتأويله للأمور، الشيء الذي يجعل مهمة وضع تعريف شامل جامع صعب للغاية.
ومع ذلك يمكن رصد بعض هذه التعاريف التي حاولت تحديد مفهوم الأمن القانوني، فمنها من اعتبره بأنه مبدأ من مبادئ القانون الأساسية التي تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار الجانبية والسلبية للقانون من خلال تناقضات أو تعقيدات القوانين واللوائح أو التغييرات المتكررة، ومنها من ذهب إلى القول بأن الحديث عن الأمن القانوني يستدعي ضرورة وضوح القواعد القانونية، وأن لا تخضع إلى تغييرات متكررة وغير متوقعة[8].
أما المجلس الدستوري الفرنسي فقد اعتبر في قرار حديث له بأن الأمن القانوني غير متعارض مع الدستور وأكد على أهمية هذا المبدأ وعلى أهمية الوضوح في القواعد القانونية[9].
بينما اتجه الفقه وكعادته إلى القول بأن الأمن القانوني هو عملية وليس مجرد فكرة تستهدف توفير حالة من الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية من خلال إصدار تشريعات متطابقة مع الدستور ومتوافقة مع مبادئ القانون الدولي، غايتها إشاعة الثقة والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام.
أما المشرع المغربي فرغم إجحافه عن وضع تعريف محدد للأمن القانوني، فقد كرس هذا المبدأ في العديد من المواضيع، أهمها المساواة أمام القانون المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور، ومبدأ حق الملكية المنصوص عليه في الفصل 35 من الدستور السابق الذكر، كل هذه مؤشرات تستمد وجودها من مبدأ الأمن القانوني الذي يقضي بضرورة انسجام النصوص القانونية مع بعضها البعض وتحديدها الدقيق للمراكز القانونية والتزامات حقوق الأفراد.
بناء على ذلك يمكن القول بأن الأمن القانوني يعني ضرورة موافقة التشريع للدستور، وإصدار قوانين خالية من العيوب الشكلية والموضوعية تبعث على الاطمئنان والاستقرار في العلاقات التعاقدية والمراكز القانونية لأنه من خلال الأمن القانوني يمكن لكل فرد أن يتوقع النتائج ويعتمد عليها فمن سيبرم عقدا سيعرف مسبقا الالتزامات الملقاة على عاتقه ونطاقها وحدودها، وكذلك ما للمتعاقد الآخر، بحيث يجب على التشريع أن لا يتسم بالمفاجأة والاضطراب، أو التضخم في النصوص، أو برجعية القوانين والقرارات الأمر الذي قد يزعزع الثقة في الدولة وقوانينها[10].
الفقرة الثانية: خصائص الأمن القانوني
من خلال التعريفات السابقة الذكر للأمن القانوني يتضح لنا بأنه يرتكز على خاصيتين أساسيتين وهما خاصية التوقعية” أولا” ثم وضوح القاعدة القانونية” ثانيا”.
أولا: خاصية التوقعية
يقضي مبدأ الأمن القانوني بأن تكون القاعدة القانونية توقعية وأن تظل المراكز القانونية قائمة ومستقرة، والاستقرار المقصود هنا هو الاستقرار النسبي من خلال حماية الحقوق المكتسبة واستقرار الأوضاع القانونية، ومن مقتضيات مبدأ التوقعية أيضا ضرورة تسهيل الولوج إلى القانون من خلال عملية الإشهار، بحيث يجب أن يعلم الجميع بهذا القانون ولن يتأتى ذلك إلا بإشهاره وإذاعته للعموم[11].
وعليه فمبدأ التوقعية في إطار القانون لا يعني فقط توقع المتقاضين والأشخاص للقاعدة القانونية والنص الذي يحكم حركاتهم وسكناتهم، ولكن يعني أيضا أن يستند القاضي للفصل في المنازعات إلى قوانين مستقرة عوض الاعتماد على قوانين أخرى مقارنة أو نظريات فقهية غير مستقرة أو قناعات شخصية.
ثانيا: وضوح القاعدة القانونية
من المبادئ المكملة لمبدأ التوقعية، مبدأ وضوح القاعدة القانونية وهذا يعني بأن القانون يجب أن يكون واضحا، وأن لا يتسم بالمفاجآت والاضطراب أو التضخم في النصوص.
لذلك فمبدأ وضوح القاعدة القانونية يعتبر من أهم عناصر مبدأ الأمن القانوني، لأن الأمر يتعلق بجودة النصوص القانونية الشيء الذي يستدعي ضرورة صياغة النصوص بشكل واضح ومفهوم، يمكن لأفراد المجتمع فهم مختلف مكونات القاعدة القانونية، وهم معنيون بالقاعدة القانونية التي تقضي بأنه” لا يعذر أحدا بجهله للقانون”، وهذا يعني ضرورة وضوح القاعدة[12] القانونية وعدم اتسامها بالمفاجآت، لأن القاعدة القانونية هي قاعدة مجردة هدفها ووظيفتها الأساسية الإقرار أو المنع أو تحديد عقوبات، وليس من وظيفتها الدخول في التفاصيل.
لذلك فكلما كانت القاعدة القانونية مغرقة في التفاصيل أو كانت خلفيتها المصدرية واسعة وغير محددة بدقة أو كانت تحمل عدة تفسيرات، كلما كانت فاعلية هذا القانون ضعيفة.
المطلب الثاني: بعض مظاهر الأمن القانوني في قانون 49.16
يعتبر الأصل التجاري من أهم ما ابتدعه الفكر القانوني التجاري تتكون عناصره عبر الزمن نتيجة للاستغلال الدائم و المتكرر والمستمر، وإلا كان عرضة للاندثار باعتباره قابلا للزوال بمجرد التوقف النهائي عن استغلاله، لأن وجوده وبقاءه مرتبط باستمرارية استغلاله، مما يجعل قيمته كمال أقل استقرارا من قيمة المنقولات المادية[13].
ونظرا لأهمية الكراء التجاري اهتم المشرع المغربي بتنظيمه من خلال إصداره لجملة من الظهائر المعدلة والمتممة ابتداء بظهير 21 مارس 1930 كأول نص خاص، لتنظيم الكراء التجاري الذي منح الحق للمكتري التجاري في تجديد عقده أو التعويض في حالة رفض التجديد[14]، مرورا بعدة ظهائر اعتبرت نقطة انطلاق لإصدار أهم تشريع ينظم المادة الكرائية وهو ظهير 24 ماي 1955 بحيث اتضح من خلال ديباجته على أن المشرع كان هدفه هو حماية الملكية التجارية وحقوق المكترين في الكراء والعمل على استقرار نشاطهم التجاري عن طريق ضبط تصرفات المكترين والحد من السلطة المطلقة للمكرين على أساس أن الحق في الكراء يعتبر الدعامة الأساسية لاستقرار الأصل التجاري واستمراريته، كمقاولة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مشروع يساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي.
غير أن، ظهير 24 ماي 1955 ما فتئ أن فقد مصداقيته التي اتضحت معالمها في العديد من المقتضيات القانونية والتي عمرت لمدة زمنية لا بأس بها أصبح معها الحفاظ على العلاقة الكرائية صعبة المنال نتيجة المقتضيات التي كرسها هذا الظهير والتي خلفت استياء كبيرا في وسط التجار والمهنيين، لذلك أصبح المشرع المغربي ملزما بضرورة مراجعة هذا الظهير في اتجاه تكريس الأمن القانوني في العلاقة التعاقدية ، فجاء قانون 49.16 كبديل جديد لظهير 24 ماي 1955، بحيث كان المشرع المغربي واعيا بضرورة مبدأ الأمن القانوني وأهميته في تحقيق الأمن التعاقدي في العلاقة التعاقدية التي تجمع بين المكري والمكتري، لذلك جاء بمجموعة من المقتضيات القانونية التي يتضح بأنها تهدف إلى ضمان حماية حقوق ومصالح الأطراف المتعاقدة والحد من أسباب النزاع التي اعتبرت من أسباب تراجع ظهير 24 ماي 1955.ولعل من أهم الضمانات التي جاء بها قانون 49.16 إقراره لشكلية الكتابة كأساس يمكن من خلالها ضمان الأمن التعاقدي ” الفقرة الأولى”، وعمل أيضا على وضع العناصر الأساسية التي يمكن اعتمادها في تحديد مبلغ التعويض المستحق للمكتري بعد ما كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة “الفقرة الثانية”.
الفقرة الأولى: شرط كتابة عقد الكراء
عقد الكراء التجاري كان يخضع في ظل ظهير 24 ماي 1955 لمبدأ الرضائية بحيث كان يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات “أولا” غير أنه واستنادا لما جاءت به المادة 3 من قانون 49.16 أصبح عقد كراء المحلات التجارية يخضع لشكلية معينة “ثانيا”.
أولا:عقد الكراء التجاري في ظهير 24 ماي 1955
استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 627 و628، عقد الكراء يعتبر من العقود الرضائية، بحيث يكفي فقط لتمام هذا العقد اتفاق المكري والمكتري على العقار محل الكراء، والأجرة المتفق عليها، دون ضرورة إفراغه في شكلية معينة، مستندا في ذلك إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهذا ما كرسه القضاء المغربي في العديد من الاجتهادات القضائية أخص بالذكر القرار الذي جاء فيه بأن “عقد الكراء في التشريع المغربي هو رضائي لا تشترط لقيامه شكليات خاصة بل يكفي اتفاق طرفيه على تحديد [15]العقار ومقابل الكراء حسب ما نص عليه الفصلان627 و628 من ق،ل،ع”.
ثانيا: عقد الكراء في قانون 49.16
حرصا من المشرع على تحقيق الأمن التعاقدي اشترط ضرورة كتابة عقود كراء العقارات بمحرر ثابت التاريخ حسب المادة 3 من قانون 49.16 والتي جاء فيها “تبرم عقود كراء المحلات أو العقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ”.
فمن خلال القراءة الأولية للمادة الثالثة من قانون 49.16 يتضح لنا بأن هاجس الإصلاح كان راسخا بذهن المشرع إذ استعمل صيغة الوجوب، وكان يريد أن يعلن منذ البداية على أنه لا مجال للتلاعب أو استغلال التفاوت الاقتصادي بين طرفي العقد أو سوء استعمال مبادئ قانونية راسخة كمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد[16]، خاصة وأن الأمر بتعلق بتصرفات ومعاملات واردة على عقارات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
ولعل هذا المقتضى من المستجدات التي جاء بها هذا القانون عكس ما كان عليه الأمر في قانون 24 ماي 1955، ولعل الشكلية المقصودة هنا ليست شكلية للإثبات فقط، وإنما هي شكلية للانعقاد، ذلك أن عقود الأكرية الرضائية لا تخضع لهذا القانون، وإنما تخضع للمبادئ العامة في قانون الالتزامات والعقود المنصوص عليها في الفصلان 627 و 628 لأن قانون 49.16 جاء من اجل حماية الأصل[17] التجاري الذي يعتبر وحدة مادية ومعنوية يستغلها التاجر من أجل إدارة مشروعه التجاريه[18].
أما العقود المبرمة خارج نطاق المادة الثالثة من قانون 49.16 فقد تساهل معها المشرع إلى ابعد الحدود بحيث قرر إخضاعها لمقتضيات هذا القانون مع منح الأطراف إمكانية الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لهذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 30[19] من القانون أعلاه، ولكن هذا المقتضى يثير العديد من الإشكالات من قبيل ما الفائدة التي ابتغاها المشرع من وجوب ورود العقد في شكلية معينة (المادة 3 من،ق، 49.16) ثم يأتي في الأخير ليقرر بأن العقود المبرمة خلاف ذلك تخضع لنفس القانون دون تحديد سقف زمني لتدارك ذلك الأمر، ودون إلزام تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة منظمة يخولها قانونها تحرير العقود؟ بل الأكثر من ذلك حينما ربط المشرع تحرير عقد الكراء في محرر ثابت التاريخ معبرا عن ذلك بصيغة الوجوب “يجب” دون أن يربط هذا الوجوب بالبطلان في حالة مخالفة هذا الشرط مع العلم أن البطلان هو الجزاء القانوني عند مخالفة قاعدة قانونية آمرة[20].
بدراسة متأنية أيضا لمقتضيات المادة 37 من ق ، 49.16 نجدها تنص على مبدأ مهم جدا، وهو إمكانية تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، والمقصود هنا أن عقود الكراء التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من القانون السابق الذكر تخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، والإشكال الذي يطرح وبشدة يتعلق بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 37 “ما لم تخضع لقوانين خاصة”
إذا كان قانون 49.16 يعتبر قانونا خاصا ينظم العلاقة الكرائية التجارية بين المكري والمكتري، وهو قانون خاص، إذا هل المشرع قصد وراء هذا المقتضى، إعطاء مفهوم خاص للعلاقة الكرائية في قانون 49.16 أم أنه وقع في عيب في الصياغة؟
ولم يقتصر هذا التضارب على المادة 37 وإنما هناك نوع من عدم الانسجام مع المادة الثالثة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 38 على أنه: “تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه، ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته”، قد حملت هذه الفقرة مجموعة من التفسيرات، إذ هناك من يفسرها بمكان تواجدها بحيث جاءت ضمن الباب الحادي عشر المتعلق بمقتضيات ختامية التي تكون عادة في النصوص القانونية لشرح تطبيق القانون في الفترة الانتقالية، أي فترة نشره بالجريدة الرسمية إلى غاية دخوله حيز التطبيق هذه الفقرة تتحدث عن عقود الكراء التي ستبرم من تاريخ نشر هذا القانون إلى غاية دخوله حيز التطبيق.
إلى أنه يمكن القول بأن الصياغة التي جاءت بها هذه المادة وخاصة عبارة المبرمة التي تفيد الماضي والحاضر والمستقبل لا تسعف في القول بأن هذه المادة خاصة بالعقود المبرمة في الفترة الانتقالية.
وعليه يمكن القول بأن المشرع المغربي كان واعيا بأهمية هذا المقتضى إذ قَلما نجد عقود كراء مبرمة كتابة في المجال التجاري الذي ينبني على الثقة ولهذا تبنى المشرع بشكل ضمني العقود الشفوية في هذا القانون وننتظر كيف سيتعامل القضاء مع هذا المقتضى.
لذلك فالمشرع المغربي كان عليه أن يستغني عن الفقرة الأخيرة من المادة 3 حتى لا يطرح أي إشكال، لأنه وحسب ما هو متعارف عليه، فالنص الخاص أولى بالتطبيق من النص العام، لأن قانون 49.16 شرع أصلا لحماية المكتري التاجر عكس قواعد القانون المدني المتشبعة بمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين، والتي تخدم مركز المالك أو الملكية العقارية على حساب المكتري التاجر.
إذا كان المشرع المغربي قد اتجه في الآونة الأخيرة إلى فرض الرسمية في العديد من التصرفات القانونية من أجل تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي ومن أجل ضمان حماية حقوق الأفراد وصيانتها من العبث أمام تعدد وتنوع المعاملات وكثرة القوانين وتشعبها من جهة، وانتشار عمليات النصب والاحتيال المستهدفة للملكية بشكل عام من جهة أخرى، هذا التوجه كرسه المشرع في العديد من التصرفات أخص بالذكر القانون المنظم للملكية[21] المشتركة والذي نص فيه على ضرورة تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة وإنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت البطلان، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار حيث جاء فيها: “يجب تحرير عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة”.
ولم يحدد أيضا طبيعة البيانات الواجب إدراجها فيه وهو موقف أكثر مرونة مقارنة بما ورد في المواد 7[22] و 8[23] من قانون 67.12[24].
بالإضافة إلى شرط الكتابة جاء المشرع المغربي بمستجد آخر يتعلق بالبيان الوصفي لحالة العين المؤجرة حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون 49.16 على أنه: “عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف”.
رغم أهمية هذا المقتضى الذي كان غائبا في ظهير 24 ماي 1955 عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبر هذا الشرط أساسيا لإبرام مثل هذه العقود، لأنه لا يمكن تصور إبرام هذا النوع من العقود دون إعداد بيان وصفي لحالة العين المؤجرة عند التسليم، لأن الهدف من هذه البيانات هي وضع حد لأي نزاع مستقبلي بخصوص حالة العين المكتراة، فإن المشرع المغربي لم يشترط شكلا معينا لتحرير هذا البيان كما لم يشر إلى الجهة التي يمكنها تحرير هذا البيان.
الفقرة الثانية: معايير تحديد التعويض في ظهير 24 ماي وقانون 49.16
لقد أدى اختلال توازن الإرادات في العلاقات التعاقدية نتيجة للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى ظهور نظرية حديثة في توجيه العقد وحماية الطرف الضعيف فيه، خاصة عندما يكون محل التعاقد عقارا وإضفاء الشفافية والمصداقية على المعاملات العقارية في سبيل ضمان حقوق المتعاملين بها[25].
وهي نفس الحماية التي أقرها المشرع المغربي لفائدة مكتري الأصل التجاري مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وباعتبار المكتري أيضا صاحب ملكية تجارية[26]، غير أن الأمر لا يبقى على إطلاقه لأنه إلى جانب الملكية التجارية للمكتري توجد ملكية عقارية أصلية للمكري يتعين احترامها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة المحمية دستوريا، ومراعاة أيضا لحقوق المكري الذي جازف بقدسية ملكيته من أجل أن يستفيد منها المكتري، انطلاقا من هذه المعادلة يصبح المكري مساهما بصفة غير مباشرة في تأسيس الأصل التجاري وإنتاج الثروة.
لذلك سنعمل على دراسة أسس تقدير التعويض في ظهير 24 ماي 1955 “أولا” مع تحديد أهم المستجدات التي جاء قانون 49.16 فيما يهم مسطرة التعويض “ثانيا”.
أولا: معايير تحديد التعويض في ظهير 1955 (الإفراغ نموذجا)
تشكل دعوى التعويض ضمانة أساسية لحماية الملكية التجارية من أي ضرر يلحق بالمكتري خاصة في حالة المطالبة بالإفراغ، وهذا المقتضى نص عليه الفصل 21 من ظهير 24 ماي 1955 حيث جاء فيه “كل مكتر يستطيع المطالبة بالتعويض عن الإفراغ أو بأحد التعويضات المنصوص عليها في الفصول من 10 إلى غاية الفصل 18 ولا يجبر على الإفراغ قبل أن يتسلم مبلغ التعويض اللهم إلا إذا دفع له رب الملك تعويضا مؤقتا على وجه الاحتياط يحدد رئيس المحكمة الابتدائية وترفع النازلة إلى الرئيس وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 27 ويحكم فيها مع إمكانية استئناف حكمه كما ينص على ذلك الفصل 30”
من خلال هذا الفصل يتضح لنا بأن المشرع عمل على حماية المكتري وضمان توصله بالتعويض المحكوم به وأن لا يبقى هذا التعويض مجرد دين في ذمة المكري يطالب به فيما بعد، وإنما يجب أن يحصل على هذا التعويض بشكل فعلي، وهو ما يمكن أن نلمسه من قرار المجلس الأعلى الذي جاء فيه “… إن إبداء الاستعداد من طرف المكري لتعويض المكتري لا يكفي بل يجب أن يتم تعويض المكتري بصورة فعلية[27]“.
وهو نفس المقتضى الذي ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره الذي جاء فيه: “لكن لما كان المعتبر في تحديد عناصر الأصل التجاري التي تدخل في تقدير التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري هي العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ أي ما قد يلحق المكتري من خسارة حقيقية وما فاته من كسب[28]“.
يتضح لنا من خلال الاجتهادات القضائية السابقة الذكر بأن تقدير التعويض كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة[29]، وتقدير التعويض كان يتم على أساس تقدير قيمة الأصل التجاري مع العلم أن الأصل التجاري يتكون من مجموعة من العناصر المعنوية والمادية، وبالتالي يصعب تقدير قيمة التعويض في ظل تنوع هذه العناصر.
ويمكن القول بأن نزاعات ظهير 24 ماي 1955 كان أساسها إفراغ المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري، وبالتالي اندثار هذا الأخير في مجمله وبكافة عناصره، والتعويض عن فقدانه بسبب الإفراغ، وبالتالي تقييم كافة العناصر المكونة له لتحديد التعويض، لذلك فجوهر النزاع هو الأصل التجاري الذي لا قيمة له دون المحل التجاري الذي يحتضنه.
ثانيا: معايير تحديد التعويض في قانون 49.16
أثارت مسألة التعويض جدلا فقهيا واسعا في ظهير 24 ماي 1955 اعتبارا لكونه كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة الشيء الذي استدعى ضرورة إعادة النظر في كيفية تقدير التعويض المستحق للمكتري، لذلك جاء قانون 49.16 بالمادة السابعة منه والتي عمل فيها على تحديد المعايير المعتمدة في تحديد التعويض المستحق للمكتري عن إنهاء عقد الكراء، ذلك أن هذه المادة نصت على أن المكتري يستحق تعويضا في حالة استحقاقه يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ عقب إنهاء عقد الكراء.
هذا التعويض يجب أن يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبة للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل، وفي حالة تقديم المكتري للمكري مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، فإن التعويض عن الإفراغ لا يمكن أن يقل عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء.
وفي المقابل منح المشرع الحق للمكري بأن يثبت بأن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة، وهذا ما ذهب إليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة حيث جاء فيه “… وبناء على المستنتجات بعد الخبرة لدفاع الجهة المدعى عليها التي عرض فيها بأن التقدير الذي اعتمد عليه الخبير على الحق في الكراء جد مبالغ فيه، ولا يتماشى مع القيمة الحقيقية للمحل وكذا الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 150 درهم، وأن الخبير لم يشر إلى الدخل وكذا التصريحات الضريبية مما تكون معه الخبرة مخالفة لما تضمنه الحكم ومقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 كما أن عنصر إدخال التحسينات غير وارد لكون أن المحل مهمل ولم يتم إدخال عليه أي تحسينات[30]“.
وهو نفس التوجه الذي تبناه الحكم الصادر عن نفس المحكمة[31].
وخلافا لما جاء في المادة 7 من القانون 49.16 بخصوص أسس تحديد التعويض الواجب أداؤه عن إنهاء عقد الكراء لفائدة المكتري فقد نصت المادة 19 من القانون أعلاه على نوعين من التعويض لفائدة المكتري في حالة الحكم بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي للسكن، حيث يمثل الأول تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات الأولى، في حين أن التعويض الثاني يوازي كراء ثمانية عشر شهرا.
وفي حالة إثبات أن طالب الإفراغ لا يتوفر على سكن، أو أن السكن الذي يتواجد به غير كاف ولا يلبي حاجياته الطبيعية يمكنه المطالبة بإفراغ المحل شريطة حصول المكتري على تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية للمحل الملحق (المادة 19 من القانون رقم 49.16)، وأشارت نفس المادة إلى مقتضى آخر مفاده أن الشخص الذي يطالب بالإفراغ يجب عليه أن يستعمل المحل شخصيا داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ مغادرته من طرف المكتري ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكن هناك عذر مقبول، وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يوازي كراء ثمانية أشهر حسب قيمة آخر وجيبة كرائية.
والملاحظ أيضا أنه لم تعد للمحكمة سلطة واسعة في تقدير قيمة التعويض أو بالأحرى قطع المشرع مع سنوات “محكمة الخبرة” وذلك بوضعه لمعايير تستند عليها المحكمة في تقدير قيمة الأصل التجاري وهي التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة.
هذا مستجد مهم من شأنه ضمان منطق الشفافية في المقاولات، إلا أنه من جهة أخرى يطرح إشكال التجار الغير مقيدين بالسجل التجاري والذين لم يصرحوا بالضريبة، هل يمكن لهؤلاء الاستفادة من التعويضات التي جاء بها هذا القانون؟ ونفس الإشكال يطرح بالنسبة للتجار الذين صرحوا بالضريبة ولكن لم يمر على ذلك التصريح أجل الأربع سنوات، طبعا هاجس الدولة في محاربة التهرب الضريبي كان حاضرا من خلال هذا المقتضى، لكن ليس على حساب قوانين خاصة بل إن ذلك يجب أن يكون في قوانين تهتم بمحاربة هذه الظاهرة، لأن هذا المقتضى سوف يطرح مجموعة من الإشكالات من قبيل ما هي الأسس التي سيعتمدها القضاء لتقدير التعويض في هذه الحالة؟
كما يطرح التعويض إشكالا آخر يتعلق بالأشخاص الذين خول لهم المشرع الحق في الكراء بمقتضى الشطر الثاني من المادة الأولى من هذا القانون، والحال أنهم لا يملكون أصلا تجاريا وهم التعاونيات والصيدليات والمختبرات الطبية، فإذا كان التعويض يعادل قيمة الأصل التجاري وهو منعدم في هذه الحالات، فعلى ماذا سيتم تعويضهم؟ هذا إشكال آخر ينضاف إلى قائمة الإشكاليات التي جاء بها قانون 49.16.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها القانون أعلاه فيما يهم مسطرة التعويض هي التحسينات والإصلاحات التي قام بها المكتري، بحيث تدخل هذه الأخيرة ضمن العناصر المشمولة بالتعويض، بل الأكثر من ذلك نصت المادة السابعة على عبارة “ما فقده من عناصر الأصل التجاري”، والحال أن الأصل التجاري هو واحد، فكيف يمكن الحديث عن تعويض الأصل التجاري ككل والتعويض عن فقدان أحد عناصره؟ فهل هذه الصياغة جاءت عن سهو أم عن قصد؟
ومع ذلك لا يمكن القول أن هذه المقتضيات سوف تضع حدا للصراع القائم بين الملكية العقاري والملكية التجارية، لأن المكري يراهن على حماية ملكيته العقارية أما المكتري فهو يسعى جاهدا للحفاظ على جميع حقوقه المرتبطة بالأصل التجاري كمؤسسة قانونية قائمة الذات، إذ بمرور الوقت سوف تطرح إشكالات أخرى، وهذه حالة طبيعة جميع القوانين والتي كما هو معلوم موجهة لتنظيم المجتمع، هذا الأخير يتغير باستمرار الشيء الذي يستدعي ضرورة مواكبة النصوص القانونية لهذا التغيير.
خاتمة
من خلال ما تمت الإشارة إليه من المقتضيات القانونية الجديدة تتضح لنا رغبة المشرع المغربي في إحاطة العلاقة التعاقدية التي تجمع بين طرفين في مركزين مختلفين قد يصل تضارب مصالحهما حد التنافر بسياج من المقتضيات التي نضمن قدرا الإمكان تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين بشكل يوفر الأمن التعاقدي والقضائي المنشودين، متجاوزا بذلك الفراغات التي اعترت ظهير 24 ماي 1955 والتي كشف عنها التطبيق القضائي مما أدى إلى تضارب الأحكام القضائية.
[1]– ظهير شريف صادر في 2 شوال 1374 الموافق ل 24 ماي 1955 بشأن عقود كراء الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، منشور بالجريدة الرسمية 2224 بتاريخ 10 يونيو 1955، ص: 1619.
[2]– الملاحظ أنه بالرغم من أهمية هذا العنصر لم يتول المشرع المغربي سواء في ظهير 24 ماي 1955الملغى أو في قانون 49.16 الجديد تعريفه، باستثناء بعض الإشارات الواردة في المادة السادسة من القانون الجديد والتي تنص على أنه: “يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة السادسة ويعتبر كل شرط مخالف باطلا”.
بينما اتجه الفقه إلى القول بأن الحق في الكراء يعتبر عنصرا من العناصر المعنوية للأصل التجاري، أنظر عز الدين بنستي: دراسات في القانون التجاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001، الجزء الثاني ص: 72.
أما أحمد شكري السباعي فقد اتجه إلى القول بأن الحق في الكراء هو عنصر يدخل عند وجوده ضمن العناصر المعنوية والمادية الأخرى التي يتألف منها الأصل التجاري، يمنح للتاجر المستثمر المكتري الحق في تجديد عقد كراء العقار أو المحل المكترى عند انتهائه بقوة القانون إذا توفرت شروط نشأته تحت طائلة تعويضات الإخلاء أو الإفراغ لا تقل عن قيمة الأصل التجاري عند الاقتضاء ضمانا لاستقرار واستثمار التجارة والتاجر”، أحمد شكري السباعي: الوسيط في الأصل التجاري –دراسة في قانون التجارة المغربية والقانون المقارن والفقه والقضاء، الجزء الثاني مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 2015، ص: 12.
وهناك من عرفه أيضا بأنه: “الحق الممنوح لمالك الأصل التجاري في تجديد عقد الكراء بعد انتهاء مدة العقد الأولى أو الاستمرار في الكراء في حالة بيع الأصل التجاري بمجموعه وتحويل الكراء إلى اسم مشتريه ولو بدون إرادة مالك العقار المؤسس فيه الأصل التجاري وكذلك التعويض عن رفض المالك تجديد العقد”، أنظر عبد العزيز توفيق: الأصل التجاري في التشريع المغربي، مقالة منشورة بمجلة رابطة القضاء العدد الأول، سنة 1981، أوردته نجاة الݣص في مرجعها “الحق في الكراء كعنصر في الأصل التجاري ومدى الحماية المقررة له في ضوء ظهير 24 ماي 1955، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب الطبعة الأولى 2006، ص: 50.
[3] – جلال محمد أمهلول: المؤسسة التجارية بين الثبات وعدم الاستقرار مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية عدد 32 سنة 1994، ص: 57-58.
[4] – ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 07 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)، ص: 5857.
[5]– من أهم هذه الأهداف :
1- السعي نحو ضمان استقرار المؤسسات التجارية
2- ضمان وضوح النصوص القانونية
3- تحقيق المرونة في المساطر المعتمدة نظرا للغموض الذي كان يشوب مجموعة من النصوص القانونية في ظهير 24 ماي 1955 والتعقيدات المسطرية التي تسببت في ضياع العديد من الحقوق.
[6]– ينص الفصل 35 من دستور 2011 على أنه: “يضمن حق الملكية ويمكنه الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.
[7] – ظهر مبدأ الأمن القانوني في ألمانيا سنة 1961، حيث أكدت المحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية على دستوريته قبل أن تتبناه باقي دول أوروبا، بحيث اعترفت به محكمة العدل للمجموعة الأوروبية في قرارها سنة 1962، وقراراتها الأخرى التي أكدت فيها على ما يسمى ب “الثقة المشروعة” التي تقترب بشكل كبير من مبدأ الأمن القانوني إلى جانب التوقع القانوني الذي أكدت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1981. أنظر عبد المجيد غميجة: مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء 28 مارس 2008.
[8] – ورد في التقرير السنوي لمجلس الدولة الفرنسي لسنة 2006 أن
« Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicabe pour provenir à ce résultat les normes édictées doivent être claires et intelligibles et ne par être soumises dans le temps à des variateurs trop fréquentes ni surtout imprévisibles ».
[9] – قرار صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 29/12/2015.
[10] -يسري محمد العصار، الحماية الدستورية للأمن القانوني، مجلة الدستورية القاهرة عدد 3 يوليوز 2003، ص 35.
[11] – عبد المحيد غميجة، مرجع سابق ص 16.
[12]– يسري محمد العصار، مرجع سابق، ص:24
[13]– محمد الفروجي: الأصل التجاري عناصره وطبيعته القانونية كمال يستغل في إطار التسيير الحر، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات 2005،ص:47
[14] – صدر الظهير مباشرة بعد فوات أربع سنوات على صدور القانون الفرنسي بتاريخ 30 يونيو 1926، وقد كان المعنيون بهذا النص التجار الفرنسيون بحكم بسط الحماية الفرنسية على المغرب، وقام المشرع المغربي بإصدار مجموعة من الظهائر كان الهدف منها تقنين العلاقة الرابطة بين المكري و المكتري على نحو يحقق العدالة التجارية، فأصدر ظهير 3 ماي 1932 وظهير 17 يناير 1948 والذي عرف بدوره تعديلين مهمين تعديل بمقتضى ظهير 22 مايو 1954، الذي اهتم بتنظيم كراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية، إلى أن جاء ظهير 24 ماي .1955، والذي عدل بدوره بواسطة قانون 49.16.
[15] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2013، 4215 بتاريخ 26-9-2013 رقم 1573-2013 أورده مصطفى بونجة في مرجعه الكراء التجاري بين ظهير 1955 والقانون رقم 49.16، منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال الطبعة الأولى 2016 ص 31.
[16] – محمد الخضراوي، إشكالية توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية (قراءة في قانون 44.00) ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التي انعقدت بسطات، أيام 26 و 27 أبريل 2007، ص 365.
[17] – عرفت مدونة التجارة الأصل التجاري في المادة79 بأنه “مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية”، من خلال هذا التعريف يتضح لنا بأن المشرع أكد على الطبيعة المعنوية والمنقولة للأصل التجاري، مع العلم أن المال المعنوي لن يكون منقولا، وانه أداة التاجر لممارسة نشاطاته وأنشطته التجارية ، انظر محمد الكشبور، قراءة في محيط المادة 112 من مدونة التجارة ، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية ، مجلة فصلية تعنى بالثقافة القانونية العدد1- اكتوبر 2009 ص:17
[18] – نجاة الكص، الحق في الكراء كعنصر في الأصل التجاري ومدى الحماية المقرة له[18] في ظهير 24 ماي 1955، مرجع سابق، ص 27.
[19] -ينص الفصل 38 من ق، 49.16 انه تخضع الأكرية المبرمة خلافا لمقتضياته الواردة في المادة الثالثة أعلاه لهذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق عقد مطابق لمقتضياته.
[20] – مصطفى بونجة، مرجع سابق، ص: 136.
[21] – قانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، صدر بتنفيذه ظهير 298/02/01 بتاريخ 03 أكتوبر 2002 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 07 نونبر 2002، ص: 3175 عدل هذا لقانون وتمم بمقتضى القانون 106.12.
[22] – تنص المادة 7 على: “أنه يجب على الأطراف المتعاقدة إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه ويجب أن يرفق هذا البيان بالعقد”.
[23] – تنص المادة 8 على أنه: “يجب أن ينجز البيان الوصفي في محرر ثابت التاريخ وأن يتضمن وصف المحل بكيفية مفصلة ودقيقة مع تجنب استعمال الصيغ من نوع حالة جيدة أو حالة متوسطة”.
[24] – ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 18 نوفمبر 2013، ص: 7328.
[25] – محمد زروق، قراءة في مقتضيات القانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز- ندوة العقار والإسكان، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش 24 أبريل 2003، ص: 142.
[26] – نجاة الكص، مرجع سابق، ص: 23.
[27] – قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 24/12/74 ملف رقم 52242 أورده أحمد عاصم في مرجعه” الحماية القانونية للكراء التجاري م.س، دراسة نظريى تطبيقية للنصوص على ضوء قرارات المجلس الأعلى، ص: 124.
[28] -قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 1306 المؤرخ في 01/12/2004 ملف تجاري عدد 826/03/02/2004 منشور بدلائل عملية الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005، ص: 125.
[29] – جاء أيضا في قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) ما يلي: “لكن حيث أن تقدير الخبرة موكول لسلطة المحكمة وأن هذه الأخيرة لما وجدت في الخبرة المأمور بها ابتدائيا من أجل الحفاظ على مقومات الخبرة التجارية قبل أن تندثر بالإفراغ والتي يمكن الرجوع إليها عند الاقتضاء إذا ثبت عدم صحة السبب فيما بعد العناصر الكافية لتكوين قناعتها والتي يجب اعتبارها في تقدير قيمة الضرر الذي قد يلحق المكتري بسبب الإفراغ اعتمدتها مستعملة سلطتها في ذلك ولا محل للنعي عليها بعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة ما دامت توفرت لديها المبررات لقضاتها…”.
-قرار المجلس الأعلى عدد 1210 المؤرخ في 03/11/2004 ملف تجاري عدد 646/03/02 منشور بدلائل عملية، المرجع السابق، ص: 126.
[30] – قرار المحكمة التجارية بوجدة الصادر بتاريخ 15/02/2018 ملف رقم 883/16/8206 حكم عدد 149/2018 غير نمنشور.
[31] – قرار المحكمة التجارية بوجدة الصادر بتاريخ 15/02/2018 ملف رقم 884/16/8206 حكم عدد 150/2018 غير منشور.